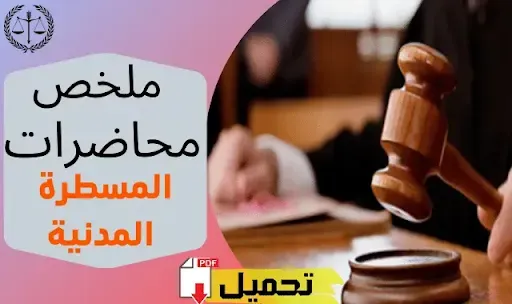بسم الله الرحمان الرحيم
ملخص محاضرات المسطرة المدنية
محاور المدخل
أولا: مفهوم قانون المسطرة المدنية
ثانيا: خصائص قانون المسطرة المدنية
ثالثا: مصادر قانون المسطرة المدنية
رابعا: المبادئ العامة لقانون المسطرة المدنية
خامسا: التطور التاريخي لقانون المسطرة المدنية بالمغرب
سادسا: مستجدات مسودة قانون المسطرة المدنية الجديد
أولا: مفهوم قانون المسطرة المدنية
1- تعريف قانون المسطرة المدنية
اختلفت التشريعات العربية في تسمية هذا القانون، حيث سماها:
-المشرع التونسي "مجلة المرافعات المدنية والتجارية"؛
-والمشرع الجزائري "قانون الإجراءات المدنية"؛
-والمشرع المصري والليبي "قانون المرافعات المدنية والتجارية"؛
-والمشرع السوري و اللبناني والأردني يسمونه "قانون أصول المحاكمات المدنية"؛
-أما المغرب فقد اعتمد مصطلح قانون المسطرة المدنية تأثرا بالتشريع الفرنسي
فهي ترجمة حرفية لمصدرها الفرنسي (procédure civel)، وهو أصل المسطرة المدنية التي أدخلتها الحماية الفرنسية إلى المغرب ضمن مجموعة الظهائر المنظمة للتنظيم القضائي بالمغرب سنة 1913 والتي تم إلغاؤها بالظهير المؤرخ بــ 14/07/1974، وهو قانون المسطرة المدنية الذي ما زال مطبقا إلى يومنا هذا.
له إطلاقان: عام وخاص.
الإطلاق العام يشمل كل ما يتعلق بالقانون القضائي الخاص.
وبالإطلاق الخاص يختص ب"القانون المتضمن للقواعد القانونية الإجرائية والمسطرية، التي يجب احترامها عند إقامة الدعوى، وكيفية الفصل فيها، وإصدار الأحكام المتعلقة بها، وطرق الطعن في هذه الأحكام؛ و كيفية تنفيذها".
يطلق قانون المسطرة المدنية في مقابل القانون المدني:
-فإذا كانت القانون المدني يمثل قانون الموضوع الذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف في علاقاتهم و مراكزهم القانونية فإن قانون المسطرة يدخل ضمن القواعد الشكلية أو المسطرية تعنى بالقواعد الإجرائية التي يتعين اتباعها لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي.
-وإذا كان تحقيق مقتضيات قانون الموضوع هو المقصود بالدرجة الأولى، فإن الوصول إلى ذلك يتوقف على إجراءات ومساطر يتعين سلوكها للوصول إلى ما يضمنه قانون الموضوع من حقوق ومراكز قانونية، مما يجعله قانون الشكل، يأخذ نفس أهمية قانون الموضوع عملا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الوسائل تأخذ حكم الغايات.
-الهاجس الأساسي لهذا الفرع من فروع القانون هو تمكين الأشخاص من اللجوء إلى المحاكم المختصة قصد الحصول على أحكام من شأنها أن تضمن لهم الوصول إلى حقوقهم والتمتع بها و توفر لهم الوسائل التي تضمن التنفيذ الجبري لما على دائنيتهم من التزامات.
-من هنا تكتسب قواعد المسطرة المدنية المغربية، أهمية خاصة إذ بفضل هذه القواعد الإجرائية تنتقل القواعد المدنية الموضوعية من حالة السكون إلى حالة الحركة حيث تبين للأفراد الخطوات والإجراءات القانونية والطرق التي ينبغي أن يسلكوها للحفاظ على حقوقهم ومراكزهم القانونية .
يطلق في مقابل قانون المسطرة الجنائية:
- مما يعني شموله للمساطر المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والأسرية وغيرها من المساطر ما عدا تلك المضمنة في المسطرة الجنائية؛لكن وفي ظل إحداث المحاكم الإدارية والتجارية وأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب، ونظرا للخصوصيات المسطرية التي تميز مختلف هذه القضايا فقد أصبحت مجموعة من الإجراءات المسطرية متضمنة في القوانين المحدثة لهذه المحاكم والأقسام، مما يجعل قانون المسطرة يفقد الكثير من مجال تطبيقه، على اعتبار أن هذه القوانين تقدم عليه بالأولوية في التطبيق، ومع ذلك يبقى قانون المسطرة المدنية يمثل الشريعة المسطرية العامة المطبقة في مختلف القضايا المدنية الشاملة لقضايا الأسرة، والقضايا الاجتماعية والإدارية والتجارية، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بكل نوع من هذه القضايا التي تطبق بالأولوية لقاعدة وجوب تقديم الخاص على العام.
2- موضوع قانون المسطرة المدنية
يتضمن قانون المسطرة المدنية مختلف القواعد والضوابط التي تنظم الدعوى المدنية ابتداء من تحديد جهة الاختصاص القضائي النوعي والمكاني، ثم تسجيل الدعوى بأول درجات التقاضي إلى حين صدور الحكم فيها وتنفيذه، مرورا بإجراءات التحقيق وممارسة مختلف طرق الطعن.
|
المواضيع الأساسية للمسطرة المدنية بمفهومها العام |
|
|
ويتعلق بالمحاكم واختصاصاتها وتأليفها وتنظيمها وتصنيفها وتفتيش المحاكم ومراقبتها (ظهير (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة). ويلحق به النظام الأساسي للقضاء والذي يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بمسارهم المهني |
التنظيم القضائي |
|
يشمل مجموعة القواعد التي تحدد المحكمة التي على المتقاضي أن يلجأ إليها وهذا ما. يسمى بقواعد الاختصاص. (الاختصاص النوعي والاختصاص المكاني) |
الاختصاص القضائي |
|
القواعد المنظمة للوسيلة التي أعطاها القانون لصاحب الحق لحماية حقه بواسطة القضاء وهي الدعوى حيث هناك القواعد المنظمة لقبول الدعوى وقواعد استعمالها وأنواعها المختلفة. |
الدعـوى |
|
تشكل القواعد المنظمة للأحكام وطرق الطعن أهمية بالغة ، بحيث لن تتقرر الحماية القضائية إلا عن طريق الحكم أو القرار الصادر من المحكمة كما أن من يعيب على هذا الحكم له الحق في الحصول على الحماية القضائية من خلال طرق الطعن ، لكل ذلك هناك قواعد لإصدار الأحكام و لآثارها و لطرق الطعن فيها |
الأحكام وطرق الطعن |
|
يقصد بذالك مجموعة القواعد الإجرائية المنظمة لشكل الأعمال التي يقوم بها الخصوم أو المحكمة بدءا من انعقاد الخصومة إلى انتهائها |
المحاكمة أو الخصومة |
|
وهي أهم مرحلة لأنه لا فائدة في الحكم إذا لم ينفذ، فتنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي. |
تنفيذ الأحكام |
ثانيا: خصائص قانون المسطرة المدنية
1- خاصية الشكلية
تتميز هذه القواعد بالطابع الشكلي لأنها تتناول الإجراءات والأشكال التي يتعين مراعاتها واتخاذها عند التجاء الأفراد إلى القضاء، وعند تعرض القضاء للفصل في المنازعات.
وإذا كان الشكل هو الغالب في قواعد المسطرة المدنية فإن بعض القواعد يعد من قبيل القواعد الموضوعية التي تنظم الحقوق من ذلك مثلا:
-القواعد الخاصة بشروط صحة الدعوى.
-القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام.
2- خاصية جمعه بين خصائص القانون العام والخاص
اختلف في طبيعة قانون المسطرة المدنية بين من يعده من القانون العام ومن يعده من القانون الخاص.
ومن تأمل قواعده يجده يجمع بين النوعين:
- القواعد التي تعنى بتنظيم وتسيير العدالة تعتبر من القانون العام.
- القواعد الخاصة بنزاعات الأشخاص وكيفية الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم تعتبر من صميم القانون.
3- خاصية ارتباط قواعده بالنظام العام (آمرة)
يتضمن قانون المسطرة المدنية الكثير من القواعد المتعلقة بالنظام العام. ومن ذلك:
-قواعد التنظيم القضائي؛ لأنها تنظم سلطة عامة من سلطات الدولة.
-قواعد الاختصاص النوعي، أما قواعد الاختصاص المحلي فلا تعتبر من النظام العام.
-بعض قواعد المحاكمة والطعن تتعلق هي الأخرى بالنظام العام لارتباطها بحسن سير القضاء.
أما قواعد المحاكمة التي يقصد منها فقط مراعاة المصالح الخاصة للمتقاضين فليست من النظام العام .
4- خاصية الطابع الجزائي
تهدف قواعد المسطرة المدنية إلى تحديد السبيل الواجب اتخاذها لترتيب الجزاء الذي قررته القوانين الموضوعية وذلك عند مخالفتها.
فإذا كان القانون المدني هو الذي يحدد أركان العقد ويعين الجزاء المترتب عند مخالفتها، فإن قانون المسطرة المدنية هو الذي يحدد لصاحب المصلحة في تقرير هذا الجزاء كيفية الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بذلك.
5- خاصية الشريعة المسطرية العامة
يعتبر ق.م.م القانون الإجرائي العام الواجب إتباعه عند الالتجاء إلى القضاء وعند الفصل في المنازعات طالما لا يوجد قانون إجرائي خاص.
وهذا يعني أن القواعد الواردة فيه هي القواعد العامة للإجراءات التي يجب إتباعها والالتزام بها بالنسبة لسائر المنازعات ، لكن إذا نص المشرع على قاعدة مسطرية خاصة أو قانون مسطري خاص خلافا لقانون المسطرة المدنية فإن القاعدة المسطرية الخاصة تكون هي الواجبة الإتباع
فالمسطرة المدنية إذن لا تقتصر على الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المدنية البحتة بل تشمل الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية كذلك
وتستبعد الدعاوى ذات الطابع الجنائي أو الإداري لأن هناك المسطرة الجنائية بالنسبة للأولى والمسطرة الإدارية بالنسبة للثانية.
لأن المسطرة المدنية تضم وتهتم فقط بالإجراءات الخاصة بنزاعات الأفراد فيما بينهم.
بخلاف المسطرتين الجنائية والإدارية اللتين تبرز فيهما الدولة دائما كطرف في النزاع ، ويبدو جليا من خلال هدف هاتين المسطرتين:
فالجنائية تعنى بالبحث عن الجرائم والتصريح بوجودها وإدانة أصحابها.
أما الإدارية فهي التي تمكن المحاكم الإدارية من البت في النزاعات التي تنشأ عن تسيير القطاع العام .
لكن رغم هذا الفارق فإن هذه المساطر على اختلاف أنواعها تقوم على نفس المبادئ الأساسية كاحترام حقوق الدفاع ووجود طرق الطعن والتزام المحاكم بالحياد...،
ويلاحظ أن المسطرة المدنية تعتبر بالنسبة للمسطرتين الإدارية والجنائية وحتى التجارية الشريعة العامة التي يلتجأ إليها لسد أي فراغ ينتج عن سكوت هذه المساطر.
وهكذا فقد نصت المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية على تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام هذه المحاكم ما لم ينص نص خاص على خلاف ذلك
وأكدت نفس القاعدة المادة 19 من قانون المحاكم التجارية إذ أجازت تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ما لم ينص نص خاص على خلاف ذلك.
وبخصوص قانون المسطرة الجنائية هناك عدة نصوص قانونية تحيل على قانون المسطرة المدنية إما صراحة أو ضمنا من ذلك مثلا:
- المادة 368 من ق م ج التي تحيل على مقتضيات ق م م في شأن تسليم الاستدعاءات.
- المادة 627 من ق م ج التي تحيل على ق م م للتعرض على وثيقة محجوزة.
- المادة 645 من ق م ج التي تحيل على ق م م لتنفيذ الشق المدني من الحكم الجنائي.
ثالثا: مصادر قانون المسطرة المدنية
1. الدستور وخاصة الباب السابع 107... 128)
2. التشريع العادي (قانون المسطرة المدنية وقوانين أخرى)
3. الاجتهاد القضائي.
4. الاتفاقات الدولية (العامة والإقليمية والثنائية).
رابعا: المبادئ العامة للمسطرة المدنية
أهم المبادئ:
1. مبدأ العلانية. (125 دستور).
2. مبدأ التواجهية
3. مبدأ حياد القاضي.
4. مبدأ تسبيب الأحكام في كل المراحل. (المواد: 50/ 345/ 375 م, م). (125 دستور).
خامسا: التطور التاريخي لقانون المسطرة المدنية
المحطات التاريخية الكبرى
1- مرحلة ما قبل الحماية (الفقه المالكي: ابن عاصم، ولامية الزقاق)
2- مرحلة الحماية: ظهير 12غشت 1913
3- مرحلة ظهير 28 شتنبر 1974.
- مرحلة التسعينات (1993 – 1997)
- بداية الألفية إلى صدور القانون 10-35 لـ 17- 9- 2011.
4- مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
سادسا: أهم توجهات مشروع قانون المسطرة المدنية
1. السياق العام لهذا المشروع
2. طريقة إعداد المشروع
3. أهداف هذه المراجعة
4. أهم مستجدات مسودة المشروع
للتحميل الملخص المرجو الضغط علي هنا